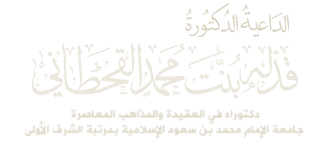تلخيص وتقريب وجمع/ د.قذلة بنت محمد ال حواش القحطاني
http://www.d-gathla.com
منهج شيخ الإسلام في تأليف الكتاب
جاهد المرجئة في هذا الكتاب بالحجج العقلية والنقلية
ويسمى الكتاب: الإيمان الكبير ، وقد قال عنه ابن عبد الهادي رحمه الله: "وله كتاب الإيمان، وهو كتاب عظيم لم يسبق إلى مثله".
احتوى الكتاب على أكثر من اثنين وعشرين فصلا تختلف بين الطول والقصر
ويتضح منهجه فيما يلي:
1-عرض آراء المخالفين وسردها بأدلتها وبراهينها السمعية والنقلية.
2-الرد على المخالفين بنصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف من الصحابة والتابعين.
3-إيراد الححج العقلية والأدلة والبراهين على تأييد رأيه.
4-شدة ذكاءه وقوة حافظته والتي تظهر من خلال حفظ نصوص الكتاب والسنة ،وأقوال الفرق ومخالفيهم من السلف.
معنى الإيمان لغة
• الإيمان لغة: يطلق على معانٍ منها: الإقرار ، والتصديق ، والأمن ضد الخوف ، والأمانة ضد الخيانة ، والثقة ، والطمأنينة، والإذعان، وإظهار الخضوع وقبول الشريعة ، والدين والخلق ، والصلاة ، والعمل الصالح وغيرها. وأقوال أهل اللغة في ذلك كثيرة جداً، أكتفي بقول الراغب حيث قال: "ويقال لكل من الاعتقاد والقول والصدق والعمل الصالح إيمان"(1).
• (1) المفردات صـ32
معنى الإيمان عند السلف
الإيمان اصطلاحاً:
أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان:
اختلفت عبارات السلف في تعريف الإيمان وبيان حقيقته، فتارة يقولون: هو قول وعمل. وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية. وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة. وتارة يقولون: قول باللسان، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح. فإذا قالوا: قول وعمل؛ فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعاً، وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام، ونحو ذلك إذا أطلق.
والإقرار القلبي يشتمل على أمرين:
الأول: اعتقاد القلب، وهو تصديقه بالأخبار.
الثاني: عمل القلب، وهو إذعانه وانقياده للأوامر. هذا من جهة اللغة.
العلاقة بين الإسلام والإيمان.
· والإسلام والإيمان إذا افترقا دل كل واحد منهما على الآخر.
· أما حال اقترانهما: فإن أهل السنة والحديث مختلفون في ذلك على قولين:
· القول الأول: إنهما مترادفان، وممن قال به: محمد بن نصر المروزي، وابن عبد البر، وقد روي هذا القول عن سفيان الثوري ونسب للبخاري، وابن حبان البستي، وأبو طالب المكي، وابن مندة، وذهب إليه ابن حزم، والبيهقي، ونسبه المروزي للجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث، ونسبه ابن عبد البر إلى عامة أهل الفقه والنظر والمتبعين للسلف والأثر().
· والقول الثاني: التفريق بينهما: وقال به جماعة من الصحابة والتابعين، منهم: ابن عباس والحسن وابن سيرين، ونقل عن كثير من السلف، منهم: قتادة، وداود بن أبي هند، وأبو جعفر الباقر، والزهري، والنخعي، وحماد بن زيد، وابن مهدي، وشريك، وابن أبي ذئب، وأحمد بن حنبل، وأبو خيثمة، ويحيى بن معين، وأبو بكر بن السمعاني، وغيرهم، من الأئمة على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما.
· والتحقيق أن القول الذي يجمع بين النصوص الواردة في هذه المسألة: أن بين الإسلام والإيمان تلازماً مع افتراق مسماهما، وإن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر، ويمثل حالة الإسلام والإيمان بحالة اقتران الشهادتين، الشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم غير شهادة الوحدانية لله تعالى، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم، وكذلك الروح والبدن،فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن، ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح، وليس أحدهما الآخر، فالإيمان كالروح، فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن، والإسلام كالبدن، ولا يكون البدن حيًا إلا مع الروح، بمعنى أنهما متلازمان.
· فالإسلام والإيمان متلازمان: لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له؛ إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. وهذا مذهب السلف وهو الصحيح؛ فإن لكل منهما حقيقة شرعية ولغوية مستقلة، وما يمكن أن يقال أنهما متلازمان في الوجود لا مترادفان في الحقيقة والمعنى، ولقوة التلازم بينهما فإذا وجد أحدهما مفرداً في نص من النصوص، فإنه لا يمكننا أن نتصوره وحده، فالغاية منهما مجتمعين أو متفرقين تحصل بذكر واحد منهما منفردا.
· وكونهما متلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذا، فكل مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف بل وبين فرق الأمة كلهم
مسألة التفاضل بين الإيمان والإسلام؟
صار الناس في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال:
- فالمرجئة يقولون: الإسلام أفضل، فإنه يدخل فيه الإيمان.
- وآخرون يقولون: الإيمان والإسلام سواء، وهم المعتزلة والخوارج، وطائفة من أهل الحديث والسنة، وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم، وليس كذلك.
- والقول الثالث: أن الإيمان أكمل وأفضل، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع، وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان.
وبهذا يتضح صحة قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وغيرها من المسائل، وكل ذلك مبناه على النصوص الشرعية وعلى عدم التقدم بين يدي الله ورسوله، فكان الحق بفضل الله حليفهم، وتحري الصواب بغيتهم.
الأدلة على زيادة الإيمان
والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات ;
· كقوله تعالى : { إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا } وهذه زيادة إذا
وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات أي وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن ; حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن ; فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذه زيادة الإيمان .
· وقال تعالى : { الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل } فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازدادوا يقينا وتوكلا على الله وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق ; بل يخافون الخالق وحده.
· وقال تعالى : { وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون } { وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم } . وهذه " الزيادة " ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم إيمانا بحسب مقتضاها ; فإن كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة وإن كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه ولهذا قال : { وهم يستبشرون } والاستبشار غير مجرد التصديق
· وقال تعالى : { وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا } .
· وقال : { هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم } وهذه نزلت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحديبية ; فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان . والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه
ولهذا قال يوم حنين : { ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها }
· وقال تعالى : { ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها }
· وفي حديث الصديق الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " { سلوا الله العافية واليقين ; فما أعطي أحد بعد اليقين شيئا [ ص: 230 ] خيرا من العافية ; فسلوهما الله تعالى } " ; فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته وتسليمه وهذا من تمام الإيمان بالقدر خيره وشره كما قال تعالى : { ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه } قال علقمة : ويروى عن ابن مسعود : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وقوله تعالى { يهد قلبه } هداه لقلبه هو زيادة في إيمانه ; كما قال تعالى : { والذين اهتدوا زادهم هدى } وقال : { إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى } .
أوجه زيادة الإيمان ونقصانه يرجع إلى جهتين :
الجهة الأولى : من جهة أمر الرب تعالى ونهيه, ويتضح ذلك بوجوه :
1- أن الإيمان يزيد وينقص من جهة الإجمال والتفصيل فيما أمروا به .
2- أنه يزيد وينقص من جهة الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم .
3- أنه يزيد وينقص من جهة علم القلب وتصديقه .
4- أنه يزيد وينقص من جهة المعرفة القلبية وهي دون التصديق .
5- أنه يزيد وينقص من جهة عمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء وغيرها .
6- أنه يزيد وينقص من جهة أعمال الجوارح الظاهرة .
7- أنه يزيد وينقص من جهة استحضار الإنسان لأوامر الدين الحنيف وعدم الغفلة عنها والدوام والثبات عليها .
8- أنه يزيد وينقص من جهة أن الإنسان قد يكون منكرا ومكذبا بأمور , لا يعلم أنها من الإيمان ثم يتبن له بعدها أنها منه , فيزداد بذلك إيمانه.
9- أنه يزيد وينقص في هذه الأمور من جهة الأمور المقتضية لها .
الجهة الثانية: أن الإيمان يتفاضل من جهة فعل العبد ويتضح ذلك بأمور :
1- أنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين , هو الإيمان الذي أمر به كل شخص , فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من الإيمان , ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك , وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به , ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لايجب على غيره إلا مجملاً , وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل.
2- أن الناس يتفاضلون في الإتيان به مع استوائهم في الواجب , وهذا الذي يظن أنه محل النزاع , وكلاهما محل لنزاع .
أصل ضلال الفرق في باب الإيمان يعود إلى شبهتين:
الأولى: تصورهم أن الإيمان كل لا يتجزأ إذا زال بعضه زال كله. ونقض هذا الأصل بمعرفة أصل أهل السنة في زيادة الإيمان ونقصانه.
الثانية: قولهم إنه لا يمكن أن تجتمع عند الإنسان طاعة ومعصية، وإيمان وكفر وإسلام ونفاق، بل إذا وجد أحدهما انتفى الآخر. ومن هنا غلطوا وخالفوا الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول. ونقض هذا الأصل بمعرفة أصل أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد، وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب، ومعصية يستحق بها العقاب، ولا يكون الشخص الواحد محموداً من وجه مذمومًا من وجه، ولا محبوباً مدعواً من وجه مسخوطاً ملعوناً من وجه، ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعاً عندهم؛ بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم؛ ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل النار. وحكى عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا: إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك.
أقوال الفرق في مسمى الإيمان
أقوال المخالفين في الإيمان:
الوعيدية من الخوارج والمعتزلة: يرون أن الإيمان يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله، فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان؛ فيلتزم الخوارج تكفير أهل الذنوب، ويحكم المعتزلة بتخليدهم في النار، وسلبهم اسم الإيمان بالكلية.
والمرجئة ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب، وهم قسمان:
والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع.
القسم الأول: قول جَهْم بن صَفْوان والصالحي ومن تبعهم: زعموا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، فلم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وهذا القول، مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة. وقد كفَّر السلف كوَكِيع بن الجراح، وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول.
القسم الثاني: من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة، كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه.
والصنف الثاني: من يقول: هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكَرَّامية. فيقولون: الإيمان هو الكلمة في الدنيا، ولا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن. وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة.
والصنف الثالث: المرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب، وقول اللسان، والأعمال ليست منه، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمناً إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه.
فالمرجئة على ثلاث مراتب:
الجهمية_-الكرامية -الماتريدية -مرجئة الفقهاء
الألفاظ وتعدد مدلولاتها في الكتاب والسنة
المؤلف رحمه الله في هذه الفصول ذكر الألفاظ التي تدل على العموم فمثلا الإيمان يشمل فعل الاوامر وترك النواهي , ويشمل الأقوال و الأفعال والاعتقاد وافعال القلوب و الجوارح وهذا ليس خاص بالأيمان بل جميع الألفاظ العامة ( كالظلم والصلاح والكفر والنفاق وهذا رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان والاعتقاد والقول بالسان وقول الكرامية الذين يقولون القول بلسان وقول الجهمية هو معرفة بالقلب او النطق باللسان وتصديق القلب كمرجئة الفقهاء
فمثلا ألفاظ
- الإيمان ,الاسلام ,الدين ،التقوى،الصلاح ويقابلها
- ألفاظ الكفر , النفاق ,الظلم , و الفساد
لفظ الصلاح: يتناول جميع أفعال الخير
لفظ الفساد :يتناول جميع انواع الشر
هدف شيخ الإسلام بإيراد هذه الألفاظ العامة ؟
- رد على المرجئة ومن وافقهم فلفظ الإيمان كغيره من (الألفاظ العامة )
كالكفر و النفاق والظلم والصلاح والفساد والإسلام والدين وهذا معروف ومعلوم في اللغة العربية
مثال الظلم ثلاثة انواع :
· ظلم الشرك
· ظلم النفس فيما دون الشرك والكفر
· ظلم الناس بعضهم بعضا في الدماء وغيرها
وهذا لا يشفع فيه ( لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة)
v أصل ضلال المرجئة والرد عليهم
- المرجئة غلطوا في أصلين:
- أحدهما: ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط، ليس معه عمل، وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقًا، وما سبق كافٍ في نقض دعواهم.
- الثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مُخَلَّد في النار، فإنما ذاك؛ لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق. والجواب عن هذا الأصل من وجوه:
- أن هذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع، وما أجمع عليه طوائف بني آدم السَّلِيمِي الفطرة وجماهير النظار، بل هذه مكابرة إن أرادوا أنهم كانوا شاكِّين مرتابين ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلاً بالحق حتى قالوا: هو لا يعرف أن الله موجود حق، والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان، بل الجهل بهذا الحق المعين.
- أما أبو الحسن فتبع جهم على أصله وقال: أن السمع ورد بضم شرائط أخر إلى تعريف الإيمان بالتصديق، وهو ألا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلاً وتركاً، وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم، فلو أتى به دل على كفره، .. وإنما كفرناه به لدلالته على فقد ما هو إيمان من قلبه؛ لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق بقلبه.
v الرد على المرجئة.
- ثم يقال: قد علمنا بالاضطرار أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمدًا رسول الله، وكان يحكم بكفرهم، فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب، إذا لم يعمل بهذا التصديق، بحيث يحبه ويعظمه، ويسلم لما جاء به.
- أن يقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه، لكن دعواكم أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب غلط؛ فكفر إبليس لعنه الله كان أشد من كفر كل كافر، ولم يصفه الله إلا بالإباء والاستكبار ومعارضته الأمر، ولم يصفه بعدم العلم، وقد أخبر الله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا معترفين بالصانع في مثل قوله: {وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ} [الزخرف: 87]
- لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه: كالخبر أو التصديق والتكذيب والأمر والنهي على مجرد المعنى من غير شيء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا غيرهما، وإنما يستعمل مقيدًا؛ ولهذا لم يجعل الله أحدًا مصدقًا للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقوهم بألسنتهم، ولا يوجد في كلام العرب أن يقال: فلان صدق فلانًا أو كذبه، إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب ولم يتكلم بذلك
v الأدلة على أن الإيمان يستلزم العمل
مما يدل من القرآن على أن الإيمان مستلزم للأعمال
· قوله تعالى: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ} [السجدة: 15]
فهذه الآية مثل قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ} [الحجرات: 15] ،
· وقوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} [الأنفال: 2] ،
· وقوله {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: 62]
· ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) وقوله: (لا يؤمن من لا يأمن جاره بَوَائِقَه) وقوله: (لا تؤمنوا حتى تحابوا) وقوله: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) وقوله: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه) وقوله: (من غَشَّنَا فليس مِنَّا ومن حَمَل علينا السِّلاحَ فليس منا).
· وقول الله تعالى: {وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ} [الإسراء: 19] ، فألزم الاسم العمل، والعمل الاسم.
· وهكذا مثل قوله: {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: 22] ، وقوله: {وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء} [المائدة: 81] ، بين سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده، ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله، ومن أضداده استئذانه في ترك الجهاد، ثم صرح بأن استئذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ودل قوله: {وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ} [التوبة: 44] على أن المتقين هم المؤمنون.
· أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل، لا على إيمان خال عن عمل، فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون نزاعاً لفظيًا مع أنهم مخطئون في اللفظ، مخالفون للكتاب والسنة، وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح، وبعض الناس يحكون -في الكتب ولا يُعَيِّنُون قائله- هذا عنهم، وأنهم يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض، ولم يرد منهم أن يعملوها، ولا يضرهم تركها، وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد .
· والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق، والمنافقين بالكذب؛ لأن الطائفتين قالتا بألسنتهما: آمنا، فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق، قال تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ} [آل عمران: 166، 167] ، فلما قال في آية البر: {أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [البقرة: 177] دل على أن المراد: صدقوا في قولهم: آمنا؛ فإن هذا هو القول الذي أمروا به وكانوا يقولونه.
· ومما على استلزام الإيمان للأعمال أنه يمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئًا مما أمر به من: الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات، مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة، ونكاح الأمهات، وهو مع ذلك مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه
· قال الله تعالى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106] وَهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه، فإن الله جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن قيل: فقد قال تعالى: {وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا} قيل: وهذا موافق لأولها فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراً، وإلا ناقض أول الآية آخرها، ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره، وذلك يكون بلا إكراه، لم يستثن المكره فقط، بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً فقد شرح بها صدراً وهي كفر. والمقصود أن تلازم الإيمان للأعمال في كل حال إلا من كان له عذر شرعي: كمن لم يقدر على النطق لكونه أخرس، أو لكونه خائفاً من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك، فهذا يمكن ألا يتكلم مع إيمان في قلبه، كالمكره على كلمة الكفر، والضرورات تقدر بقدرها.
· أن مثل الأعمال من الإيمان، كمثل الشهادتين أحدهما من الأخرى في المعنى والحكم، فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد، وكذلك كالروح والبدن، فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن، ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح، وليس أحدهما الآخر، فالإيمان كالروح، فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن، والأعمال كالبدن، ولا يكون البدن حيًا إلا مع الروح الذي هو الإيمان، وهذا هو معنى أنهما متلازمان
· أنه لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه، من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة، فقال في تحقيق ذلك: {فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ} [الأنبياء: 94] ، وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: {وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى} [طه: 75] ، فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقاً ينقل عن الملة، ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام، فهو كافر كفراً لا يثبت معه توحيد، ومن كان مؤمناً بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله عاملاً بما أمر الله، فهو مؤمن مسلم، ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز ألاّ يسمى مسلما، ولجاز أن المسلم لا يسمى مؤمناً بالله
الأدلة على ابطال المجاز
إبطال دعوى المجاز
ادعى المرجئة أن دلالة الأعمال على الإيمان من باب الدلالة المجازي؛ فإن الألفاظ تنقسم في دلالتها إلى حقيقة ومجاز:
والحقيقة أن المجاز بدعة شرعية ولغوية:
· أما كونه بدعة شرعية: فإنه لم يرد في كتاب والله ولا سنة رسول الله لا نصاً ولا مفهوماً ولا إشارة.
· أما كونه بدعة لغوية: فلكونه لم يرد في كلام العرب ولم يسمع منهم لا مباشرة ولا بواسطة.
وأول من عرف أنه تكلم بلفظ [المجاز] أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه. ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة. وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل، فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله: [إنا , ونحن] ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز اللغة يقول الرجل: إنا سنعطيك. إنا سنفعل، فذكر أن هذا مجاز اللغة. والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم. قالوا: إن معنى قول أحمد: من مجاز اللغة. أي: مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك. قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له.
واشتهر القول بالمجاز في المائة الرابعة، وظهرت أوائله في المائة الثالثة وما علمته موجودا في المائة الثانية اللهم إلا أن يكون في أواخرها.
والمرجئة، المتكلمون منهم والفقهاء منهم، يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيماناً مجازاً؛ لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه؛ ولأنها دليل عليه، ويقولون: قوله: " الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شُعْبَة أفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إمَاطَةُ الأذَى عن الطريق " مجاز.
والمجاز باطل من عدة جهات:
ü أما بطلان المجاز من جهة أصله ووضعه (اصطلاح المتكلمين):
1. أنه حادث فالقول به متأخر جدا عن زمن الاحتجاج باللغة وعلى خلافه فهم الناس وعملوا.
2. ولو سلمنا أن له حاجة من باب البيان والشرح فهو وارد من جهة غير مؤتمنة لا على اللغة تفهم منها وضعاً، ولا على الشرع تفهم منها تأويلاً.
3. تصريح منظريهم ومن قرر هذا التقسيم أنه ليس المراد من هذا التقسيم إلا رد دلالات النصوص، وهذه معارضة صريحة لأصل الإيمان وممن صرح بذلك الجرجاني.
ü أما بطلانها شرعاً: فلأن الله بين في كتابه أن اللغة إلهام وتوفيق منه قال سبحانه: (وعلم آدم الأسماء كلها...) وقال (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان).
ü أما بطلانها من حيث الواقع: فبينهم وبين إثبات أن الناس اجتمعوا لوضع اللغة خرق القتاد، فمن حضر هذا الاجتماع؟ وماذا جرى فيه؟ ومن نقلته بالإسناد؟!!
· وبهذا يتضح أن اللغة توفيق وإلهام من الله تعالى:
4. وأيضًا فإنه يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما سمعوها قط من غيرهم. والعلماء من المفسرين وغيرهم لهم في الأسماء التي علمها الله آدم قولان معروفان عن السلف.
5. أحدهما: أنه إنما علمه أسماء من يعقل واحتجوا بقوله: {ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ} [البقرة: 31] . قالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل والثاني: أن الله علمه أسماء كل شيء وهذا هو قول الأكثرين كابن عباس وأصحابه،
6. لما تفطن بعضهم لبطلان دعوى التقسيم، وأنه لا حقيقة له وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا، فعلم أن هذا التقسيم باطل.. لجأ إلى القول بأن اللفظ إن دل بمجرده فهو حقيقة، وإذا لم يدل إلا مع القرينة فهو مجاز، وهذا أمر يتعلق باستعمال اللفظ في المعنى، لا بوضع متقدم،
قال اهل المجاز:
الحقيقة العرفية حقيقة لجماعة تواطئوا على نقلها، ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد بها ذلك المعنى العرفي، ثم شاع الاستعمال فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال؛ ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب.
ثم هم يعلمون ويقولون: إنه قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ، فيصير المعنى العرفي أشهر فيه ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه، فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال الحادث للعرفي وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وضع.
فعلم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز باعتبار الاستعمال لا يصح، ويجاب عن ذلك اختصاراً، أن يقال:
1. فإن الاستعمال يقتضي إقامة الدليل وبينهم وبين إثبات ذلك كما سبق خرق القتاد.
2. أنها ليست إلا مجرد دعوى وتحكم بلا دليل؛ لأنه يمكن قلب الأمر فيقال: الذي جعلته أولاً هو ثانياً، وكذا العكس، ولا دليل على رد هذا، كما أنه لا دليل عندي على إثبات دعواك، فالقولان من جنس واحد ولا مرجح فبقيت الدعوى باطلة.
ü بطلان المجازمن جهة لوازمه الفاسدة ومنها:
1. أن الطبائع والفهوم والاستعمال والألسن هذه كلها كانت معطلة عن تصور المعاني وفهمها والنطق بها، حتى وضع لها وضع، ثم عطل استعمالها في الوضع الأول فوضع لها وضع آخر، وهذا باطل.
2. ومن لوازمه أيضاً أنه يعود على اللغة بالإبطال
3. ومن لوازمه أن يعود على العلوم بالإبطال.
4. ومن لوازمه أن يعود على الشرع بالإبطال.
5.ومن لوازمة رفع الثقة بين الناس.
أقسام الناس في الإيمان
وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع الإطلاق وقال تعالى { ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات } . فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره ; فلا يدخل فيه الشرك الأكبر . وفي " الصحيحين " { عن ابن مسعود أنه لما أنزلت هذه الآية : { الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم } شق ذلك على أصحاب النبي [ ص: 80 ] صلى الله عليه وسلم وقالوا : أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك ; ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : { إن الشرك لظلم عظيم } } .
ظالم لنفسه :فيما دون الكفر مقتصد ..
مقتصد :قائم بالمأمورات وترك المنهيات مثل الفرائض وترك المحرمات
سابق بالخيرات :فعل المأمورات وانتهى عن المنهيات وزاد عليها
فعل النوافل وترك النوافل وفضول المباحات
متى ينتفي الإيمان:
- بالكفر الاكبر
- النفاق الأعتقادي
- الشرك الأكبر
- مثال:
من عبد غير الله
- او دعا غير الله
- او انكر أمرا واجبا وجوبه أو تحريمه مما اجمع المسلمون على وجوبه كالصلاة ... او تحريمه كالخمر والزنا..
موانع إنفاذ الوعيد
- موانع من جهة العبد :
المذنب: التوبة، الاستغفار، الحسنات الماحيات.
- موانع من جهة الخلق:
دعاء المؤمنين، إهداء القربات، الشفاعة في أهل الكبائر.
- موانع من الله:
المصائب المكفرة، عذاب القبر، أهوال القيامة، العفو من الله.
المسائل المتفرقة من هذا الكتاب:
قاعدة في الإيمان
اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان، فلابد أن يكون قد ترك أو فعل محرماً،فيكون من أهل الوعيد
مثال: ( من غشنا فليس منا)
مسألة: لوازم الإيمان
ومما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى { إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون } فنفى الإيمان عن غير هؤلاء فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين .
قوله تعالى : { إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم } .
وقوله : { إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم }
وقوله { إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه }
ومن ذلك قوله تعالى { عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين } { لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين }
{ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون } .
وهذه الآية مثل قوله : { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله }
وقوله : { ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء } بين سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة يستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله
ومن أضداده استئذانه في ترك الجهاد ثم صرح بأن استئذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ودل قوله : { والله عليم بالمتقين } على أن المتقين هم المؤمنون .
سؤال:هل يستلزم ماسبق نفي الإيمان عن كل من لم يتصف بهذه الصفة؟
أجاب عنه شيخ الإسلام بجوابين:
-أن يكون ماذكر مستلزما لما ترك
مثل الخوف والوجل فهما تدفعان صاحبهما لفعل الواجبات وترك المحرمات.
وقيل من عطف الخاص على العام
حكم الزنديق.
تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته، هل يَرِث ويُورَث؟ على قولين، والصحيح: أنه يرث ويُورَث وإن علم في الباطن أنه منافق، كما كان الصحابة على عهد النبي صلىالله عليه وسلم؛ لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة، لا على المحبة التي في القلوب، فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، وهو ما أظهره من موالاة المسلمين فقول النبي صلىالله عليه وسلم: " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " لم يدخل فيه المنافقون وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، بل كانوا يُورَثون ويَرِثون، وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين، وقد أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع هذا لم يقبل ذلك منهم فقال: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ} [التوبة: 54].
ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق. فقيل: يستتاب. واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان النبي صلىا لله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل أمرهم إلى الله. فيقال له: هذا كان في أول الأمر، وبعد هذا أنزل الله: {مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً} فعلموا أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلوا، فكتموه.
والزنديق: هو المنافق، وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق، قالوا: ولا تعلم توبته؛ لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر، وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق، ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتيلهم، والقرآن قد توعدهم بالتقتيل.
مسألة: هل يحاسب العبد على كل أقواله:
وقد اختلف أهل التفسير: هل يكتب جميع أقواله؟ فقال مجاهد وغيره: يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه، وقال عكرمة لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر.
والقرآن يدل على أنهما يكتبان الجميع؛ فإنه قال:{مّا يّلًفٌظٍ مٌن قّوًل} نكرة في الشرط مؤكدة بحرف[من]؛ فهذا يعم كل قوله.
وأيضاً، فكونه يؤجر على قول معين أو يؤزر، يحتاج إلى أن يعرف الكاتب ما أمر به وما نهى عنه، فلابد في إثبات معرفة الكاتب به إلى نقل.
وأيضاً فهو مأمور، إما بقول الخير، وإما بالصُّمات.
فإذا عدل عما أمر به من الصُّمَات إلى فضول القول الذي ليس بخير، كان هذا عليه، فإنه يكون مكروهاً، والمكروه ينقصه؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم "من حُسْنِ إسلام المرء تَرْكُه ما لا يَعنِيه".
فإذا خاض فيما لا يعنيه، نقص من حسن إسلامه، فكان هذا عليه، إذ ليس من شرط ما هو عليه، أن يكونه مستحقاً لعذاب جهنم وغضب اللّه، بل نقص قدره ودرجته عليه.
ولهذا قال تعالى:{لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة:286].
فما يعمل أحد إلا عليه أو له، فإن كان مما أمر به، كان لهوإلا كان عليه.
الاستثناء في الإيمان والأقوال فيه.
الاستثناء في الإيمان بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، فالناس فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: من يحرمه، وهم الماتريدية. فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم، ممن يجعل الإيمان شيئًا واحدًا يعلمه الإنسان من نفسه، كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه، وكما أنه لا يجوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله، كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لكن إذا كان يشك في ذلك فيقول: فعلته إن شاء الله، قالوا: فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة.
القول الثاني: من يوجبه، وهم الأشاعرة والكلابية. والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان:
المأخذ الأول: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنًا وكافرًا، باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به.
وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان، مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثني في الإيمان فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله ; لأنه نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلدون في النار، وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك، وهو دائما ينصر - في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم - قول أهل الحديث لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهم فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم ; فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء.
قول أهل السنة في مسألة الإستثناء
القول الثالث: جواز الأمرين
قال شيخ الإسلام:
ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين، وهذا أصح الأقوال.
وقد احتج الإمام أحمد بن حنبل وغيره، على أنه يستثنى في الإيمان دون الإسلام، وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. قال الميموني: سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في: أنا مؤمن إن شاء الله؟ فقال: أقول: مؤمن إن شاء اللّّه، وأقول: مسلم ولا أستثني، قال: قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي: نعم، فقلت له: بأي شيء تحتج؟ قال لي: {قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات: 14] ، وذكر أشياء. وقال الشَّالَنْجِيّ: سألت أحمد عمن قال: أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث، ولا أعلم ما أنا عند اللّه؟ قال: ليس بمرجئ. قال أبو عبد الله: إذا كان يقول: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فاستثنى مخافة واحتياطاً، ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثنى. للعمل. قال أبو عبد الله: قال الله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ} [الفتح: 27] أي: أن هذا استثناء بغير شك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل القبور: " وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون " أي: لم يكن يشك في هذا، وقد استثناه.
ومما سبق يتضح أن مآخذ السلف في الاستثناء، ما يلي:
1- أن الإيمان المطلق شامل لكل ما أمر الله به والبعد عن كل ما ينهى عنه، ولا يدعي أحد إنه جاء بذلك كله على التمام والكمال.
2- أن الإيمان النافع هو المتقبل عند الله.
3- البعد عن تزكية النفس، وليس هناك تزكية لها أعظم من التزكية بالإيمان.
4- أن الاستثناء يكون في الأمور المتيقنة غير المشكوك فيها كما جاءت بذلك السنة
، وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف:
- يدخل فيه المؤمن حقاً.
- ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة، وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمان، وفي الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر.
- ويدخل فيه الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم، لكن معهم جزء من الإيمان والإسلام يثابون عليه.
تعريف الكبيرة
وقد ذكرت ضوابط كثيرة للكبيرة، وأحسنها قول الماوردي: كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر.
وورد عن الإمام أحمد مثله، وكونه الأحسن؛ لكونه أنه يشتمل على كل ما ثبت في النصوص أنه كبيرة، فيشمل ما ورد فيه الوعيد: من حد، وما قيل فيه ليس منا، وما ورد فيه نفي الإيمان عمن ارتكبه؛ لأن النفي لا يكون لترك مستحب ولا فعل صغيرة.
حكم مرتكب الكبيرة:
إن حقيقة من لم يكن من المؤمنين حقاً، لكونه من أهل الكبائر، يقال فيه: إنه مسلم، ومعه إيمان يمنعه الخلود في النار، وهذا متفق عليه بين أهل السنة، لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟
هذا هو الذي تنازعوا فيه.
قيل: يقال: مسلم، ولا يقال: مؤمن.
وقيل: بل يقال: مؤمن.
والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، فلا يعطي اسم الإيمان المطلق، فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق، واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله؛ لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه، وهو لازم له كما يلزمه غيره، وإنما الكلام في اسم المدح المطلق يدخل فيه
إجماع الأمة على حكم مرتكب الكبيرة
و ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار ; فإن هذا القول من البدع المشهورة وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان ; وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان واتفقوا أيضا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته .
ففي " الصحيحين " عنه أنه قال : " { لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة } " وهذه الأحاديث مذكورة في مواضعها .
حجية الإجماع
الكتاب، والسنة، والإجماع، فمدلول الثلاثة واحد، فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب، وكذلك كل ما سنه الرسول صلىالله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك، وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون، فإنه لا يكون إلا حقاً موافقاً لما في الكتاب والسنة، لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول، وأما الرسول فينزل عليه وحي القرآن، ووحي آخر هو الحكمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: " ألا إني أوتِيتُ الكتابَ وِمْثَله معه ".
وقوله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 115] وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة؛ من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول، وأن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن الرسول، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين، فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر، كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به، فهنا قد لا يقطع _ أيضًا _ بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ، والصواب في خلاف هذا القول، وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر .
أهم المراجع
1-كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية.
2-فهارس مجموع الفتاوى جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد
3-شرح كتاب الإيمان لفضيلة الشيخ د.عبدالعزيز الراجحي (شرح صوتي )
4-الأفنان في تقريب وتلخيص كتاب الإيمان تلخيص/صلاح الخلاقي