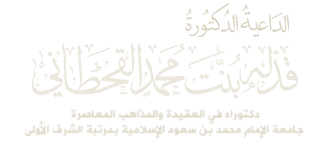فوائد من كتاب الداء والدواء
للإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله -
تعريف موجز بالإمام ابن قيم الجوزية
اسمه ونسبه: هو الإمام العالم الرباني ،ذو الذهن الوقاد،والقلم السيال ،والمؤلفات الفذة،شمس الدين ،أبو عبدالله ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية.
مولده ونشأته: ولد الإمام ابن القيم في السابع من صفر سنة 691ه، في زرع ،قرية من قرى حوران ،تبعد قريبا من خمسين ميلا عن مدينة دمشق الشام .
ونشأ في بيت علم ودين وفضل.
طلبه للعلم : يقول الحافظ ابن رجب: (تفقه في المذهب وبرع وأفتى ،ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وتفنن في علوم الإسلام ،وكان عارفا في التفسير لا يجارى فيه ،وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى ، والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك ،وبالفقه وأصوله ،وبالعربية وله فيها اليد الطولى ،وعلم الكلام ، والنحو...وغير ذلك وكان عالما بعلم السلوك، وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم ،له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى.. وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد ،وطول صلاة إلى الغاية القصوى ،وتأله ،ولهج بالذكر ، وشغف بالمحبة، والإنابة، والافتقار إلى الله تعالى،والانكسار له، والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته، لم أشاهد مثله في ذلك)[1]
مؤلفاته: له العديد من المؤلفات منها: "زاد المعاد في هدي خير العباد" ،و"هداية الحيارى من اليهود والنصارى" ،و "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل"،
و "مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين" ،و"الداء والدواء" وغير ذلك كثير.
وفاته: توفي رحمه الله في الثالث عشر من رجب سنة 751ه ومازالت آثاره -بحمدالله – سراجا وهاجا يضئ مشاعل الهداية للناس.
تعريف عام بكتاب الداء والدواء
هذا الكتاب من أهم وأعظم ما صنف في باب الأخلاق والتربية و تزكية النفوس .
وأصله سؤال وجه إلى الإمام ابن قيم الجوزية نصه:(ما تقول السادة العلماء أئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين - في رجل ابتلي ببلية، وعلم أنها إن استمرّت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقّدَا وشدة؛ فما الحيلة في دفعها؟ وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى ، "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" ، أفتونا مأجورين)
فانبرى الإمام للإجابة والإعانة والفتوى، فكان هذا الكتاب النافع.
فوائد من الكتاب
· الدعاء دواء
والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه، ويمنع نزوله، ويرفعه، أو يخففه إذا نزل. وهو سلاح المؤمن، وله مع البلاء ثلاث مقامات:
أحدها: أن يكون أقوى من البلاء، فيدفعه.
الثاني: أن يكون أضعف من البلاء، فيقوى عليه البلاء، فيصاب به العبد. ولكن قد يخففه، وإن كان ضعيفًا.
الثالث: أن يتقاوما، ويمنع كلّ واحد منهما صاحبه.
· آفة استعجال الإجابة
من الآفات التي تمنع ترتُّبَ أثرِ الدعاء عليه: أن يستعجل العبد، ويستبطئ الإجابة، فيستحسرَ، ويدَعَ الدعاء.
وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يستجاب لأحدكم ما لم يعجَلْ، يقول: دعوتُ، فلم يُستجَبْ لي".
· أوقات وشروط استجابة الدعاء
وإذا جمع الدعاءُ حضورَ القلب وجمعيتَه بكلّيته على المطلوب، وصادف وقتًا من أوقات الإجابة الستة وهي: الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإِمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم ؛ وصادف خشوعًا في القلب، وانكسارًا بين يدي الربّ، وذلاًّ له، وتضرّعًا ورِقّةً؛ واستقبل الداعي القبلة، وكان على طهارة، ورفع يديه إلى الله تعالى، وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنّى بالصلاة على محمَّد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدّم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله، وألحّ عليه في المسألة، وتملّقه، ودعاه رغبة ورهبة ، وتوسّل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدّم بين يدي دعائه صدقة، فإنّ هذا الدعاء لا يكاد يُرَدّ أبدًا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة، أو أنها متضمنة للاسم الأعظم.
· الدعاء كالسلاح
والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحدّه فقط، فمتى كان السلاح سلاحًا تامًّا لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلّف واحد من هذه الثلاثة تخلّف التأثير.
· التداوي بالفاتحة
ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرًا عجيبًا في الشفاء.
ومكثتُ بمكة مدّةً تعتريني أدواء، ولا أجد طبيبًا ولا دواء، فكنتُ أعالج نفسي بالفاتحة، فأرى لها تأثيرًا عجيبًا. فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألمًا، وكان كثير منهم يبرأ سريعًا.
ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطّن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها، هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحلّ، وقوة همة الفاعل وتأثيره.
· حسن الظن بالله
ولا ريب أنّ حسن الظن إنّما يكون مع "الإحسان" فإنّ المحسن حسن الظن بربه أنّه يجازيه على إحسانه، ولا يخلف وعده، ويقبل توبته. وأما المسيء المصرّ على الكبائر والظلم والمخالفات، فإنّ وحشة المعاصي والظلم والإجرام تمنعه من حسن الظن بربه.
قال الحسن البصري: إنّ المؤمن أحسن الظنَّ بربّه، فأحسن العمل. وإنّ الفاجر أساء الظنَّ بربّه، فأساء العمل.
وبالجملة، فحسن الظن إنّما يكون مع انعقاد أسباب النجاح. وأما مع انعقاد أسباب الهلاك، فلا يتأتّى إحسان الظن.
· الفرق بين حسن الظن والغرور
وأنّ حسن الظن إن حمل على العمل، وحثَّ عليه، وساق إليه، فهو صحيح. وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي، فهو غرور.
وحسن الظن هو الرجاء. فمن كان رجاؤه حاديًا له على الطاعة، زاجرًا له عن المعصية، فهو رجاء صحيح. ومن كانت بطالته رجاءً، ورجاؤه بطالةً وتفريطًا، فهو المغرور.
· أسباب تفاوت الناس في الإيمان والعمل
فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدمُ استحضاره وغَيبتُه عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها، لاشتغاله بما يضادّه، وانضمّ إلى ذلك تقاضي الطبع، وغلَباتُ الهوى، واستيلاءُ الشهوة، وتسويلُ النفس، وغرورُ الشيطان، واستبطاءُ الوعد، وطولُ الأمل، ورقدةُ الغفلة، وحبُّ العاجلة، ورُخَصُ التأويل، وإلفُ العوائد ، فهناك لا يمسك الإيمانَ إلا الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا.
ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان حتى ينتهي إلى أدنى أدنى مثقال ذرة في القلب.وجمَاعُ هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر.
· الخوف والرجاء النافع
وهو سبحانه كما جعل الرَّجاء لأهل الأعمال الصالحة، فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة . فعُلِمَ أنّ الرَّجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل الصالح. قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61)} [المؤمنون: 57 - 61].
وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت : أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: "لا ،يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلّون ويتصدّقون، ويخافون أن لا يُتقبَل منهم. أولئك يسارعون في الخيرات".
والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن.
ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. ونحن جمعنا بين التقصير- بل التفريط- والأمن!
· من آثار المعاصي
ذكر أبو نُعَيم عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي الدرداء قال: لِيحذَرْ امرؤ أن تلعنه قلوبُ المؤمنين، من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري ممّ هذا؟ قلتُ: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله، فيُلقي الله بغضَه في قلوب المؤمنين، من حيث لا يشعر. حلية الأولياء لأبي نعيم(1/215)
وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمَّد بن سيرين: أنّه لمّا ركبه الدَّينُ اغتمّ لذلك، فقال: إنّي لأعرفُ هذا الغمَّ بذنب أصبتُه منذ أربعين سنة! حلية الأولياء (2/271)
وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنّهم لا يرون تأثيرَه في الحال، وقد يتأخّر تأثيره فيُنسَى ، ويظنّ العبد أنه لا يغبِّر بعد ذلك.
· من آثار المعاصي: حرمان العلم
فإنّ العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور.
ولمّا جلس الشافعيّ بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته، وتوقّد ذكائه، وكمال فهمه؛ فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورًا، فلا تطفئه بظلمة المعصية.
· المعاصي توهن القلب والبدن.
أما وهنها للقلب، فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته وأما وهنها للبدن، فإنّ المؤمن قوته من قلبه ، وكلّما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الفاجر ، فإنّه وإن كان قويَّ البدن، فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوجَ ما يكون إلى نفسه.
· المعصية تورث الذلَّ
فإنّ العزّ كلّ العزّ في طاعة الله تعالى. قال تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا} [فاطر: 10] أي: فليطلبها بطاعة الله، فإنّه لا يجدها إلا في طاعته.
· من عقوبات المعاصي أنّها تطفئ من القلب نارَ الغيرة
من عقوبات المعاصي: أنّها تطفئ من القلب نارَ الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته وناره التي تُخرج ما فيه من الخَبَث والصفات المذمومة، كما يُخرج الكِيرُ خَبَث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همّةً أشدُّهم غيرة على نفسه، وخاصته، وعموم الناس.
ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أغيرَ الخلق على الأمة، والله سبحانه أشدّ غيرةً منه، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغيَرُ منه، والله أغيَرُ منّي"
فالغيور قد وافق ربّه سبحانه في صفة من صفاته، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها، وأدخلَتْه على ربّه، وأدْنَتْه منه، وقرّبتْه من رحمته، وصيّرتْه محبوبًا له.
· المعاصي تمحق بركة الدين والدنيا
فإنها تمحق بركة العمر، وبركة الرزق، وبركة العلم، وبركة العمل، وبركة الطاعة. وبالجملة، تمحق بركة الدين والدنيا.
فلا تجد أقلَّ بركةً في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وكما أنّ تقوى الله مَجلَبة للرزق، فتركُ التقوى مجلبة للفقر، فما استُجْلِبَ رزقُ الله بمثل ترك المعاصي.
· ومن عقوبات المعاصي: أنّها تُضْعِف في القلب تعظيمَ الربّ جل جلاله
فالذنوب تُضْعِف في القلب تعظيمَ الربّ جل جلاله وتُضْعِف وقارَه في قلب العبد، ولابدّ، شاء أم أبى. ولو تمكّن وقارُ الله وعظمتُه في قلب العبد لما تجرّأ على معاصيه.
· الرب يكفي من كل شئ ولا يكفي عنه شئ
فالله سبحانه يعوّض عن كلّ ما سواه ، ولا يعوّض منه شيء.ويغني عن كل شيء، ولا يغني عنه شيء. ويجير من كل شيء، ولا يجير منه شيء، ويمنع من كل شيء ، ولا يمنع منه شيء.
· مراتب البعد من الله
والبعد من الله مراتب بعضها أشدّ من بعض. فالغفلة تبعد العبد عن الله، وبعدُ المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله.
· المعاصي تجعل صاحبها من السفلة
ومن عقوباتها: أنها تجعل صاحبَها من السِّفْلة بعد أن كان مُهَيًّأ لأن يكون من العِلْية. فإنّ الله خلق خلقَه قسمين: عِلية وسِفلة، وجعل علّيين مستقرّ العلية، وأسفل سافلين مستقرّ السفلة. وجعل أهل طاعته الأعلَين في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته الأسفلِين في الدنيا والآخرة.
فكلّما عمل العبد معصيةً نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين. وكلّما عمل طاعة ارتفع بها درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلَين.
· من آثار المعاصي: سوء الخاتمة
وإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكّن منه الشيطان، واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن الله ، وعطّل لسانَه عن ذكره، وجوارحَه عن طاعته، فكيف الظنّ به عند سقوط قواه، واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع ،وجَمْع الشيطانِ له كلَّ قوته وهمّته، وحَشْدِه عليه بجميع ما يقدر عليه، َ لينال منه فرصته، فإنّ ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانُه ذلك الوقت، وأضعف ما يكون هو في تلك الحال؟ فمَن تُرى يَسلَمُ على ذلك؟
فهناك {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (27)} [إبراهيم: 27].
فكيف يوفَّق لحسن الخاتمة من أغفل اللهُ سبحانه قلبَه عن ذكره، واتّبَعَ هواه، وكان أمره فُرُطًا؟
· المعاصي تمحق النعم الحاصلة وتقطع النعم الواصلة
ومن عقوباتها: أنها تُزيل النِّعَمَ الحاضرةَ، وتقطع النعم الواصلة، فتُزيل الحاصلَ، وتمنع الواصلَ . فإنّ نعم الله ما حُفِظ موجودُها بمثل طاعته، ولا استُجْلِبَ مفقودُها بمثل طاعته، فإنّ ما عنده لا يُنال إلا بطاعته.
· المعاصي تنسي العبد نفسه
ونسيانُه سبحانه للعبد: إهمالُه، وتركُه، وتخلّيه عنه ، وإضاعتُه؛ فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم!
وأما إنساؤه نفسَه فهو: إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به، يُنسيه ذلك جميعَه، فلا يُخطِره بباله، ولا يجعله على ذكره، ولا يصرف إليه همّتَه فيرغبَ فيه، فإنه لا يمرّ بباله حتى يقصدَه ويُؤثِره.
وأيضًا فيُنسيه عيوبَ نفسه ونقصَها وآفاتِها، فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها.
وأيضًا يُنسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامَها، فلا يخطر بقلبه مداواتُها..
· من عقوبات المعاصي الخسف بالقلب
ومنها: الخسف بالقلب، كما يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف به إلى أسفل سافلين، وصاحبه لا يشعر. وعلامة الخسف به أن لا يزال جوّالًا حول السفليات والقاذورات والرذائل، كما أنّ القلب الذي رفعه الله وقرّبه إليه لا يزال جوّالًا حول العرش.
· القلب السليم
ولا تتمّ له سلامته مطلقًا حتى يسلَم من خمسة أشياء: من شركٍ يناقض التوحيد، وبدعةٍ تخالف السنّة، وشهوةٍ تخالف الأمر، وغفلةٍ تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة حُجُب عن الله، وتحتَ كل واحدٍ منها أنواع كثيرة تتضمّن أفرادًا لا تنحصر.
· النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة
وقد ركّب الله سبحانه في الإنسان نفسًا أمّارةً ونفسًا مطمئنّة، وهما متعاديتان، فكلُّ ما خفّ على هذه ثَقُل على هذه، وكلّ ما التذّت به هذه تألّمت به الأخرى. فليس على النفس الأمّارة أشقُّ من العملِ لله، وإيثارِ رضاه على هواها؛ وليس لها أنفعُ منه. وليس على النفس المطمئنّة أشقُّ من العمل لغير الله، وإجابةِ داعي الهوى؛ وليس عليها شئ أضرُّ منه. والملَك مع هذه عن يَمنةِ القلب، والشيطان مع تلك عن يَسْرةِ القلب. والحرب مستمرة لا تضع أوزارها إلا أن تستوفي أجلَها من الدنيا. والباطل كلّه يتحيّز مع الشيطان والأمّارة، والحقّ كلّه يتحيّز مع الملَك والمطمئنّة. والحروب دُوَل وسِجال، والنصر مع الصبر. ومن صَبَر، وصابرَ، ورابَطَ، واتّقى الله، فله العاقبة في الدنيا والآخرة.
· فالصبر على غضّ البصر أيسرُ من الصبر على ألم ما بعده .
من حفظ هذه الأربعة أحرز دينَه : اللحظات، والخطرات، واللفظات، والخطوات.
وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة.
النظر أصل عامّة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإنّ النظرة تولّد خطرةً، ثم تولّد الخطرة فكرةً، ثم تولّد الفكرة شهوةً، ثم تولّد الشهوة إرادةً، ثم تقوى فتصير عزيمةً جازمةً،
فيقع الفعل، ولا بدّ، ما لم يمنع منه مانع.
· منافع غض البصر:
1- أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده.
2-أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم -الذي لعلّ فيه هلاكه- إلى قلبه.
3- أنّه يورث القلب أنساً بالله وجمعية عليه، فإنّ إطلاق البصر يفرّق القلب ويشتّته، ويُبعده من الله. وليس على القلب شيء أضرّ من إطلاق البصر، فإنّه يوقع الوحشة بين العبد وبيّن ربه.
4- أنه يقوّي القلب ويفرحه، كما أنّ إطلاق البصر يضعفه ويحزنه.
5-أنه يُكسب القلب نورًا، كما أنّ إطلاقه يكسبه ظلمة. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كلّ ناحية، كما أنّه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشرّ عليه من كل مكان.
6-أنّه يُورثه فراسةً صادقةً يميّز بها بين الحقّ والباطل والصادق والكاذب.
7-أنّه يورث القلب ثباتًا وشجاعةً وقوةً، فيجمع الله له بين سلطان النصرة والحجة وسلطان القدرة والقوة.
8- أنه يسدّ على الشيطان مدخله إلى القلب، فإنّه يدخل مع النظرة، وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثّل له حسنَ صورة المنظور إليه، ويزيّنها، ويجعلها صنمًا يعكف عليه القلب.
9- أنّه يُفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاقُ البصر ينسيه ذلك، ويحول بينه وبينه، فينفرط عليه أمره، ويقع في اتّباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه.
10- أنّ بين العين والقلب منفذًا وطريقًا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب.
· مفاسد داء العشق
1- الاشتغال بحبّ المخلوق وذكره عن حبّ الربّ تعالى وذكره. فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما الآخر، ويكون السلطان والغلبة له.
2- عذاب قلبه بمعشوقه. فإنّ من أحبّ شيئًا غير الله عُذّب به، ولابدّ.
والعشق، وإن استعذبه صاحبه، فهو من أعظم عذاب القلب.
3- أنّ العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه، يسومه الهوانَ، ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه.
4- أنّه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه. فليس شيءٌ أضيعَ لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور.
أمّا مصالح الدين فإنّها منوطة بلَمّ شَعَثِ القلب وإقبالهِ على الله، وعشقُ الصور أعظم شيءٍ تشعيثًا وتشتيتًا له.
وأمّا مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين، فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه، فمصالح دنياه أضيَعُ وأضيَعُ.
5- أنّ آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشّاق الصور من النار في يابس الحطب.
وسبب ذلك أنّ القلب كلّما قَرُبَ من العشق وقويَ اتصالُه به بَعُدَ من الله، فأبعد القلوب من الله قلوب عشّاق الصور. وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات ،وتولاه الشيطان من كل ناحية. ومن تولاّه عدوُّه واستولى عليه ،لم يدَعْ أذىً يمكنه من إيصاله إليه إلا أوصله.
6- أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهنَ، وأحدث الوسواسَ. وربما التحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها.
7- أنّه ربما أفسد الحواسّ أو بعضها إمّا فسادًا معنويًا أو صُوريًّا.
أمّا الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، فإنّ القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، فيرى القبيح حسنًا منه ومن معشوقه، فهو يعمي عينَ القلب عن رؤية مساوي المحبوب وعيوبه، فلا ترى العين ذلك، ويُصِمّ أذنَه عن الإصغاء إلى العذل فيه، فلا تسمع الأذن ذلك.
وأما إفساده للحواسّ ظاهرًا، فإنّه يُمرِض البدن ويُنهِكه، وربما أدّى إلى تلفه، كما هو معروف في أخبار من قتلهم العشق.
8- أنّ العشق -كما تقدّم- هو الإفراط في المحبة بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيّله وذكره والفكر فيه، بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه. فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية والنفسانية، فتتعطل تلك القوى، فيحدث بتعطّلها من الآفات على البدن والروح ما يعِزّ دواؤه أو يتعذّر، فتتغيّر أفعاله وصفاته ومقاصده، ويختل جميع ذلك، فيعجز البشر عن صلاحه.
· دواء العشق
ودواء هذا الداء القتال: أن يعرف أن ما ابتُلي به من هذا الداء المضادّ للتوحيد إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن الله فعليه: أن يعرف توحيد ربه وسننه وآياته أولًا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، ويكثر اللجأ والتضرّع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه وأن يرجع بقلبه إليه.
وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله.
أربعة أنواع من المحبّة يجب التفريق بينها:
أحدها: محبة الله. ولا تكفي وحدها في النجاة من عذابه والفوز بثوابه ،
فإنّ المشركين وعبّاد الصليب واليهود وغيرهم يحبّون الله.
الثاني: محبة ما يحبّه الله .وهذه هي التي تُدخله في الإسلام، وتُخرجه من الكفر،وإنما تكمل هذه المحبة بمحبة ما يحب الله تعالى ، وأحبُّ الناس إلى الله أقوَمُهم بهذه المحبة وأشدّهم فيها.
الثالث: الحبّ لله وفيه. وهي من لوازم محبة ما يحبّ،ولا يستقيم محبة ما يحب إلا بالحبّ فيه وله.
الرابع :المحبة مع الله. وهي المحبة الشركية، وكلّ من أحبّ شيئًا مع الله، لا لله ولا من أجله ولا فيه، فقد اتخذه ندًّا من دون الله، وهذه محبة المشركين.
· لذّات الدنيا ثلاثة أنواع:
فأعظمها وأكملها: ما أوصل إلى لذة الآخرة. ويثاب الإنسان على هذه اللذة أتمّ ثواب. ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجهَ الله من أكله وشربه ولبسه ونكاحه، وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوّه، فكيف بلذة إيمانه ومعرفته بالله، ومحبته له ، وشوقه إلى لقائه، وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم؟
النوع الثاني: لذة تمنع لذة الآخرة، وتُعقِب آلامًا أعظمَ منها، كلذّة الذين اتخذوا من دون الله أوثانًا مودةَ بينهم في الحياة الدنيا، يحبّونهم كحبّ الله، ويستمتعون بعضهم ببعض..
ولذّةِ أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلوّ بغير الحق.
وهذه اللذّات في الحقيقة إنّما هي استدراج من الله لهم، ليذيقهم بها أعظم الآلام، ويحرمهم بها أكملَ اللذّات.
النوع الثالث: لذة لا تعقِبُ لذةً في دار القرار ولا ألمًا، ولا تمنع أصل لذة دار القرار، وإن منعَتْ كمالَها. وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة. فهذه زمانها يسير، ليس لتمتُّعُ النفس بها قدر، ولابدّ أن تشغل عمّا هو خير وأنفع منها .
وهذا القسم هو الذي عناه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "كلّ لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميَه بقوسه، وتأديبَه فرسه، وملاعبتَه امرأته؛ فإنهنّ من الحقّ".
فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حقّ، وما لم يعن عليها فهو باطل.
تمت بحمدالله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.